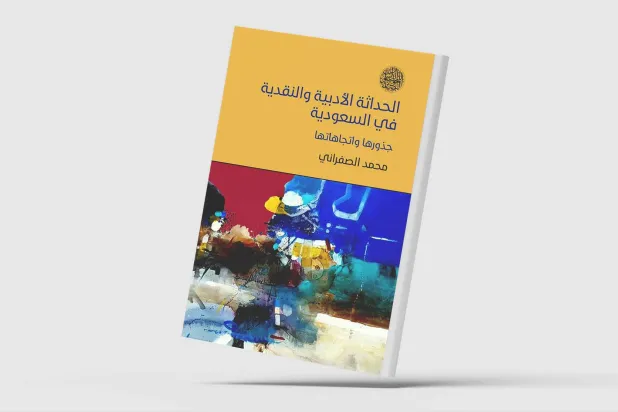يتناول كتاب «الحداثة الأدبية والنقدية في السعودية: جذورها واتجاهاتها»، للأكاديمي السعودي الدكتور محمد الصفراني، والصادر عن مركز أبو ظبي للغة العربية؛ بالرصد والتحليل جانباً من تاريخ الأدب والنقد في السعودية، يعمل من خلاله المؤلف في تحليل ودراسة الكثير من المؤلفات الأدبية خصوصاً في مجال الشعر، والكثير من المؤلفات النقدية لكتاب سعوديين.
ويتناول الكتاب جانباً من تاريخ الأدب والنقد في السعودية بالرصد والتحليل، ليجيب عن بعض الأسئلة المعرفية المركزية المهمة ومنها: كيف تشكلت الحداثة في الأدب والنقد في السعودية؟ وهل كانت السعودية في منأى عن الفكر التقدمي في الأدب والنقد في مراكز الثقافة العربية منذ بدايات القرن العشرين؟ وما الذي جعل الحراك الأدبي والنقدي الذي جرى في السعودية مبكراً، يغيب عن معظم كتب الأدب العربي الحديث؟
وتتوزع الإجابة عن التساؤلات عبر فصول الكتاب؛ فالفصل الأول بعنوان «ملامح النشأة الأدبية»، تناول أبرز مظاهر الحراك الأدبي في السعودية منذ أقصى عمق تاريخي مثبت. وتناول الفصل الثاني أبرز الفنون الأدبية مثل: الشعر، والمقالة، والقصة القصيرة، والرواية، والسيرة الذاتية، وأبرز المحطات التي تخلقت فيها هذه الفنون وأبرز الأسماء السعودية التي تفاعلت معها إبداعاً ونشراً.
الحداثة المترددة
أما الفصل الثالث، وهو بعنوان «الحداثة المترددة»، فيذكر فيه المؤلف أن الحداثة في السعودية مرت بما يمكن تسميتها «الحداثة المترددة»، وهى التي ظن دعاتها أنهم على وعي بها، وبمتغيرات المرحلة ومتطلباتها، في حين أنهم يعيشون في الماضي فكراً وتصوراً وثقافة، وخير من يمثل الحداثة المترددة عبد القدوس الأنصاري، الذي يعدونه رائد مدرسة تجديدية محافظة، هدفها إحياء التراث العربي القديم، في عصر الازدهار الأدبي، في العصر العباسي الثاني، وقد اجتهد الأنصاري وأنصار هذه المدرسة في نقد الفكر الجامد، واستبدال فكر جديد قائم على التراث الأدبي في الشعر والنثر يه. وحين ندقق في منجز الأنصاري نجده متردداً، لا ينتمي إلى القديم ولا الحديث، يتقدم خطوة ويعود متراجعاً عنها آلاف الخطوات. ثم قدم المؤلف في هذا الفصل دراسة نقدية وافية عن شعر الأنصاري.
وتناول المؤلف في الفصل الرابع «جذور الحداثة»، فيذكر أن الحداثة في السعودية تكاد تنحصر في حقل نقد الشعر تحديداً، فقد نشأت لصيقة بجنس الشعر، ومتجلية في تقنيات كتابته، وهذا جعلها موضوعاً نقدياً وإبداعياً في آن واحد.
وذكر المؤلف أن مرحلة نشأة مفهوم الحداثة في نقد الشعر السعودي بدأت في الفترة ما بين عامي 1920م و1980م، وتبدأ بكتاب «خواطر مصرحة» لمحمد حسن عواد عام 1926م، وتنتهي بكتاب «الشعر الحديث في الحجاز» لعبد الرحيم أبو بكر عام 1977م، وكتب أخرى صدرت في تلك المرحلة. وقد شكلت هذه الكتب وغيرها علامات بارزة على طريق نشأة مفهوم الحداثة في نقد الشعر السعودي.
ثم عرض المؤلف لجذور الحداثة عند محمد حسن عواد، من خلال كتابه «خواطر مصرحة»، وجذور الحداثة عند عبد الله عبد الجبار، من خلال كتابه «التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية»، وجذور الحداثة عند عبد الرحيم أبو بكر، من خلال استعراض كتابه «الشعر الحديث في الحجاز». وخلص المؤلف إلى أنه من خلال استقراء أبرز الكتب النقدية الصادرة في تلك المرحلة، يتضح أن مصطلح الحداثة أشير إليه بمصطلحات متعددة مثل: العصرية، والمعاصرة، والتطوير، والتجديد، والتنوير، والتقدم، والتحديث… لكن المفهوم الذي انطوت عليه هذه المصطلحات لا يبتعد في جوهره كثيراً عن مفهوم الحداثة الشعرية، كما تبلور مستقبلاً.
قد يهمك أيضًا: الفرنسية «ليا غاريك» قدساوية حتى 2026
وفي الفصل الخامس، وهو بعنوان «ترجمان الحداثة»، طرح المؤلف قضية السبق التاريخي في كتابة شعر التفعيلة، التي أغفلت دور محمد حسن عواد في هذه القضية. واستعرض المؤلف حياة العواد وبيئته التي نشأ فيها وعصره، وكيف أثّرت على إنتاجه الأدبي، ثم عرض لرموز السبق في الأدب العربي الحديث في شعر التفعيلة، أمثال محمد فريد أبو حديد وأحمد باكثير، ونازك الملائكة، وبدر شاكر السياب.
ثم تحدث عن السبق التاريخي للعواد في كتابة شعر التفعيلة من خلال قصيدته «خطوة إلى الاتحاد العربي» التي كتبها بين عامي 1916 و1925، وعرض لآراء بعض النقاد التي تؤيد سبق العواد في كتابة شعر التفعيلة، من خلال إثبات السبق نصياً، ومدونة العواد الشعرية، ومرحلة النشر في الصحف، وعرض لبعض نصوص الشاعر العواد من شعر التفعيلة وتاريخ كتابتها ونشرها في الصحف والدواوين وما كُتب عنها من نقد وتحليل.
وفي الفصل السادس، وهو بعنوان «مفهوم الحداثة»، يذكر المؤلف أن الشعر السعودي الحديث خطا خطوات متقدمة في سبيل الحداثة، وأصبح مصطلح الحداثة من المصطلحات الملتبسة في بعض الأذهان نظراً لما رافق نشأته وطرحه من تجاوز المألوف النقدي، وهذا جعل الوسط الأدبي السعودي ينقسم في استقباله إلى فريقين: فريق استقبله بالرفض، وفريق استقبله بالقبول والترويج.
ويشير المؤلف إلى أن نشأة الحداثة في الشعر السعودي استغرقت ستين عاماً تقريباً من المقاربات النقدية النظرية والتطبيقية ليتم طرح المصطلح وبلورة المفهوم، وتبدأ بكتاب «الكتابة خارج الأقواس» لسعيد السريحي عام 1986م، ويبلور السريحي مفهوم الحداثة ويعرِّفها بأنها «صرخة احتجاج من الإنسان ضد كل تنظيم يحاول تعليبه في أطر جاهزة. ويوجد كتاب آخر وهو «الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية» لعبد الله الغذامي، وفيه يعلن الغذامي أزمة المنهج النقدي في دراسة النص الشعري، ورغبته في تجاوز التقاليد النقدية والأدبية المتوارثة. ونرى أن الكتابين يعلنان تحول النقد في السعودية إلى مرحلة ما بعد الحداثة، وقد حفلت السنوات السابقة لصدور كتاب «الكتابة خارج الأقواس» بتوظيف مناهج النقد الأدبي الحديث التي بدأ توظيفها خارج نطاق الشعر السعودي، من خلال كتاب «شعر أبي تمام بين النقد القديم ورؤية النقد الجديد» لسعيد السريحي.
وعرض المؤلف بشكل مفصل قراءة لكثير من الكتابات الخاصة بنقاد سعوديين عن مصطلح الحداثة، وكذلك أطروحات النقاد العرب في نقد الشعر السعودي، والذين طرحوا فيها مصطلح الحداثة وبلوروا مفهومها.
وفي الفصل السابع، وهو بعنوان «تجليات الحداثة»، قدم المؤلف قراءة تفكيكية حرة لنص «الأوقات» للشاعر محمد الثبيتي، بوصفه نموذجاً لشعر الحداثة في السعودية، وثمرة من ثمارها على المستوى الإبداعي. وقسم قراءته إلى: قراءة أولية، وتفكيك النص. وخلص المؤلف إلى أن الإبداع هو مادة النقد الأدبي، وأن تطور المادة وتقدمها يقضي بالضرورة إلى تطور النقد وتقدمه، وأن الحداثة النقدية في السعودية كانت وما زالت تسير في توازٍ مع الإبداع الذي يعي جوهر العمل الإبداعي الشعري ويصنع الفارق في الوقت نفسه.
وفي الفصل الثامن، وهو بعنوان «الحداثة الملتبسة»، يذكر المؤلف أن الحداثة المترددة التي أسسها عبد القدوس الأنصاري، ظلت تسري في الساحة النقدية السعودية منتجةً ما يمكن تسميتها «الحداثة الملتبسة»، ونعني بها تلكمُ الكتابات النقدية التي تقوم على تدوين انطباع القارئ عن النص، وإصدارها في كتاب تحت مسمى النقد، وأن نقد الشعر السعودي مُني بمجموعة كبيرة من المؤلفات التي تقع في إطار النقد الملتبس بالحداثة، وتعتمد كتاباتها على الانطباع المبنيّ على ذوق الكاتب وتذوقه النصوص الشعرية التي يقاربها، دون البناء على مناهج نقدية معروفة، أو مقولات نظرية ومفاهيم إجرائية.
وينتقل المؤلف إلى الفصل التاسع من هذا الكتاب وهو بعنوان «اتجاهات الحداثة»، والذي تناول فيه اتجاهات الحداثة في نقد الشعر السعودي، ومحاولة التعرف على طرائق إعلان المناهج النقدية وتوجهات النقاد إلى الطرائق والمناهج، وعرض ذلك من خلال عينة بحثية عبارة عن دراسات من مجلة «علامات»، وتشمل إحدى وثلاثين دراسة طُرحت في ملتقى قراءة النص الثاني المنعقد عام 2002م في نادي جدة الأدبي.
وعرض في هذه الدراسة طرائق إعلان النقاد مناهجهم النقدية، لمحاولة الكشف عن المناهج النقدية التي وظَّفها النقاد في دراساتهم، وقياس توجهات النقاد إلى المناهج النقدية. وذكر أن قراءتنا لأي دراسة نقدية لا بد أن تتم في ضوء منهجها النقدي.