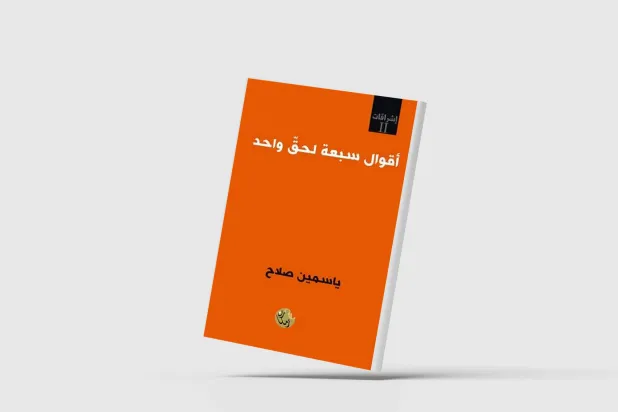ضمن سلسلة «إشراقات» الشعرية، التي يختارها ويشرف عليها الشاعر السوري أدونيس، أصدرت منشورات «زمكان» في بيروت، ديوان «أقوال سبعة لحق واحد» للشاعرة المصرية ياسمين صلاح. يمثل الديوان صرخة أنثوية مفعمة بالتساؤلات الوجودية، عبر ذات ترى العالم على أنه هاوية، والحياة سقوطاً، منذ لحظة السقوط الأول من رحم الأم. ذات محمَّلة بتاريخ من قمع الأنثى، وعواطفها، وجسدها. ذات منغمسة في قبح العالم، وتعاينه كل صباح، فتشتبك مع الزمن، ومع الوجود، والميثولوجيا، تستمع إلى صوت الموتى، كما تُصغي إلى صوت الأسماك في المحيطات. ذات تتعثر في ظلها، وترى أنه أفضل حالاً منها، بفضل شبحيته، وافتقاره للجسد والعقل والعواطف.
بدأت الذات الشاعرة معركتها مع الوجود منذ الطفولة، حين تعاملت مع الحياة بوصفها خطأ عابراً، لكنها ستكتشف لاحقاً أن ثمة أخطاء لا يمكن تصويبها «بكف صغيرة ينطبع عليها الحبر، استقبلت الحياة كخطأ إملائي». ويتبدى النزوع الأنثوي في الديوان على أكثر من مستوى، ابتداءً من مخاطبة الأم فيما يشبه العتاب، ليس عتاباً شخصياً، بل عن تاريخ طويل وممتد، تاريخ عابر للأشخاص ونياتهم، يفرض حضوره الباطش الملوث بالدماء، تقول:
«أمي..
أبحث في ذاكرتي
لا أجد إلا الدماء
فأعرف أن أسلافي لم يورثوني غير الإدانة»
هنا، تتجلى العلاقة الملتبسة للإنسان بذاكرته، مستودع التاريخ والأرشيف، أرشيف الأنا الشخصية، والأنا الجماعية، وأرشيف الوجود كله، هذا التاريخ المفعم بالدماء، سواء دماء البشر جميعاً في حروبهم الدموية، أو دماء الإناث، ضحايا القمع الذكوري. وفي الحالتين، فإن هذه الذات تحمل عبء إرث الأسلاف، ووصمة الإدانة التي لم يورِّثوها شيئاً غيرها، سواء الإدانة بصفتها أنثى، أو الإدانة بوصفها إنسانة بشكل عام، ووريثة لهذا التاريخ الدموي.
ثمة عالمان متناقضان، تعيش بينهما الذات الشاعرة: ثنائية الرقة والقسوة. الداخل والخارج. رقة الداخل ونعومته وأنثويته، وقسوة الخارج وفظاظته وذكوريته… إنها تصف ما يمور في الداخل قائلةً:
«كل ما يدور داخلي أنثوي
حتى الأفكار داخلي ترتدي تنانير
بينما تخرج على فمي بسيقانها المكشوفة»
تستدعي مفردة «داخلي» نقيضها «خارجي»، منبئةً عن هذا الانقسام والتشظي بين الداخل والخارج، وبينهما الجسد، الحد الفاصل بين الداخل والخارج، مفعم بما داخله من أفكار أنثوية باذخة الرقة، ومثخن بالندوب التي تتركها فيه أبوية العالم وسلطويته. إنه جسد مضغوط، محاصر بين نقيضين، كل منهما يحاول العبور والنفاذ من خلاله. الأفكار الداخلية الحالمة تسعى للنفاذ للتحقق في العالم الخارجي، والعنف الخارجي يسعى للنفاذ، عبر هذا الجسد، للفتك بهذه الرومانتيكية الأنثوية.
إن الجسد هنا هو فضاء المعركة بين النقيضين وساحة اشتباك، إنه المكان الذي يتهدم إثر المعركة الممتدة زمنياً من لحظة الميلاد حتى لحظة الرحيل، فالزمن ليس فسحة للانعتاق بل يغدو مجالاً لتمدد الصراع، لتتعمق الهاوية الوجودية التي سقطت فيها الذات الشاعرة، وتتسع آثار الخراب في المكان/ الجسد، بمرور الزمن، وتتفكك الأعضاء واحداً بعد الآخر. تقول:
«الأيام جعارين متشابهة
تصفح أيضًا: إناءان فخاريان من مقبرة «سار» الأثرية
تحمل اللعنة في هيكلها
تتدحرج على وجهي
وتلتهم أعضائي
هذا الكامل هو ظلي الناجي
أما أنا بلا سيقان لأقف على طولي
أو لأتعلم الهرب»
مفارقة أخرى تتوالد عبر جدل الثنائيات، وهي مفارقة الاكتمال والنقصان، الظل والأصل؛ فالظل، تابع الجسد أو شبحه، أكثر اكتمالاً من الأصل، من الأعضاء المستلَبة المتآكِلة، التي تلتهمها لعنة الوجود المأزوم. وأسلوبياً، تأتي كل الأفعال (تحمل، تتدحرج، تلتهم) في صيغة المضارعة، دوالَّ على الديمومة، فضلاً عن السخرية الكامنة في استعارة «الأيام جعارين»، فالجعران تميمة الحظ السعيد للمصري القديم، يحمل له البعث من جديد وتجدد الشباب، لكن الأيام هنا تبدو حاملة لكل ما يناقض هذه المعاني، بل إنها حاملة اللعنة.
تدرك الذات الشاعرة أن هذه اللعنة، لعنة الوجود الأنثوي في عالم بطريركي، لا تخص ذاتها المفردة، لذا كثيراً ما تتكئ على رموز ميثولوجية أو حكائية خاضت التجربة ذاتها، إذ «عبَّرت الميثولوجيا عن تعطش الإنسان إلى التحرر من القيود»، فتستعير هذه الشخصيات الأسطورية مستدفئةً بوجودها، بدءاً من عنونة إحدى القصائد باسم «ليليث»، التي تعد «أول تمرد على الذكورية، بالانطلاق من قوة المرأة وأنوثتها»، حسبما تؤكد في الهامش، وهذا التأكيد له دلالته على قصدية الشاعرة. كما تعنون إحدى القصائد بـ«أليس في بلاد العجائب»، وقصيدة أخرى بـ«بجماليون»، في إشارات إلى الرغبة في البحث عن عالم جديد، وإعادة خلق العالم ولو شعرياً عبر فضاء النص، عوالم متخيَّلة بلا هذه الجروح الوجودية. كما تستدعي من التراث الديني فُلك نوح، قائلةً: «وأرى في الأفق/ فُلك نوح ما زال يُبنى على مهل/ وكلنا كلنا لن نلحق به»، فالبشرية في حاجة إلى إعادة إنقاذ نفسها، بأن تعيد إنتاج فُلك نوح التي تحمل الناجين من طوفان الوجود الهادر، لكنها تؤكد، عبر تقنية التكرار، أن «كلنا» لن نشهد هذه اللحظة، ولا أحد من الأجيال الراهنة سينجو.
تتعاطف هذه الذات مع الطبيعة، المرادفة للأنوثة، وتتماهى معها، وتراها تقف بوصفها «قائداً وحيداً في ساحة حرب»، لكن الطبيعة قادرة على التمرد وإعلان الغضب، فقد «ملَّت رعونتنا/ حبستنا في جحورنا/ صدرها المراهق يصهل لأول مرة/ بعد أن أزاحتنا فجأة وبلا سابق إنذار»، ورغم ارتباط الطبيعة بالأنوثة، والحضارة بالذكورة، فإن الذات تبدو قاصرة عن مجاراة الطبيعة في تمردها وانفجارها، فتمرد الذات يظل فعلاً مرجَأً، ورغبة مشتهاة، وفعلاً منقوصاً، وحتى رغبات الجسد تظل فعلاً مؤجَّلاً، غير قادر على التحقق:
«جرأتي التي لم أمارسها بعد
جنوني الذي لم يكتمل
لحظة بلا ألم
ترتعش في فم الأرض».
ويصل إحساس الذات الشاعرة بأزمتها إلى حد أنها تحسد ظلها، الذي نجا من معركة الحياة، فهو بلا روح، وبلا جسد، وبلا رغبات، ولا يملك طموحاً في التمرد، ولا الاكتمال عبر وجود آخر، لذا فإنه «يتمتع بطمأنينة لا تملكها صاحبته»، ومن ثم تعلن الذات إعلاناً ثورياً، ولكنه بمثابة إعلان تام للانهزام، قائلةً: «نحتاج تعديلاً جينياً/ لنتحول جميعاً إلى ظلال مطمئنة».