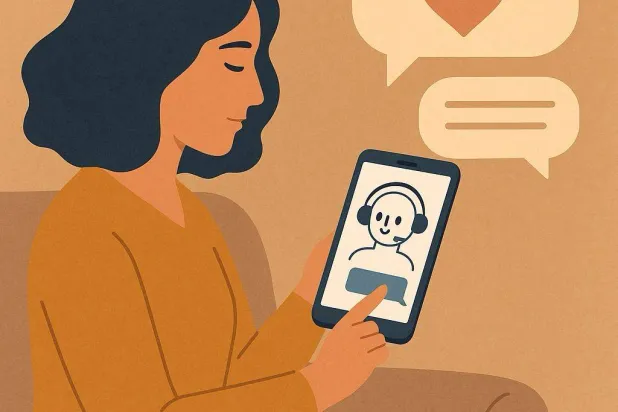في زمن تتسارع فيه نبضات العلم أسرع من دقات قلب المريض، ويقف فيه الطب النفسي على عتبة تحوُّل غير مسبوق، بين حاجة ملحَّة إلى مزيد من الأيدي البشرية، وإغراء الانفتاح على عقول اصطناعية لا تنام، يطلُّ ابتكار جديد يطمح إلى أن يكون أكثر من مجرد تقنية. إنه الصديق الذي يصغي بلا ملل، والمستشار الذي لا يُحرجك بالسؤال، والرفيق الذي يزورك في لحظات العزلة، وكل ذلك بلغتك ولهجتك، وبإيقاع يلامس روحك قبل عقلك.
إنه الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، ولكن هذه المرة ليس قادماً من وادي السيليكون أو مختبرات الشركات العملاقة؛ بل هو مولود في قلب جامعة سعودية، على أيدي فريق بحثي نسائي يؤمن بأن التغيير الحقيقي يبدأ من نبض الثقافة المحلية، لا من قوالب مستوردة.
في منطقتنا العربية، تظل الصحة النفسية ساحة صراع بين الحاجة الملحَّة والمخاوف الصامتة. فالأرقام التي لا تُعلن، والحكايات التي تُروى همساً، تكشف عن معاناة أوسع بكثير مما يظهر على السطح.
كم من شخص يبتسم أمام الكاميرا، بينما ينهار في ليل غرفته! وكم من شاب أو سيدة يخفون جروحهم العاطفية خلف ستار القوة، خشية أن تُفسَّر معاناتهم بأنها ضعف أو قلة إيمان؟
العائق الأكبر ليس نقص الموارد العلاجية أو قلة الاختصاصيين فقط؛ بل تلك الوصمة الاجتماعية التي تجعل طلب المساعدة النفسية أمراً يثير الحرج أكثر من المرض نفسه. ومع قلة مراكز الدعم، وازدحام العيادات، وارتفاع التكلفة، تتسع الفجوة بين من يحتاج إلى المساندة ومن يحصل عليها فعلاً.
هنا يطل الذكاء الاصطناعي التوليدي كجسر غير مرئي، ولكنه حقيقي في أثره. جسر يربط من يعاني في صمت بالمعلومة الصحيحة، والنصيحة الملائمة، أو حتى الإحالة السريعة لمختص، وكل ذلك بعيداً عن العيون والأحكام المسبقة.
انه لا يسألك عن اسمك، ولا يطلب منك تبرير دموعك، ولا يُقاطعك بنصائح جاهزة؛ بل يمنحك مساحة آمنة وسرِّية، تتحدث فيها بحرية تامة، لتجد من يصغي إليك في أي ساعة، وفي أي مكان، دون خوف من أن يُساء فهمك أو يُساء الحكم عليك.
في فبراير (شباط) 2025، أشرقت من جدة إشارة علمية جديدة تحمل بصمة عربية، حين نشرت المجلة الدولية للتقنيات التفاعلية عبر الهاتف المحمول (International Journal of Interactive Mobile Technologies – iJIM) دراسة بحثية بعنوان: «Dawwen: An Arabic Mental Health Mobile App Based on Natural Language Processing».
لم تكن هذه الدراسة مجرد ورقة بحثية تضاف إلى أرشيف المجلات العلمية؛ بل كانت إعلاناً عن ولادة فكرة يمكن أن تغيِّر طريقة تعاملنا مع الصحة النفسية في العالم العربي.
وراء هذه الفكرة 4 باحثات من كلية الحاسوب وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز في جدة: أروى والي، وهنا المقرّبي، وسارة الفقي، ومريح جخدار.
4 عقول نسائية اجتمعت على قناعة واحدة: أن التكنولوجيا يجب أن تنطق بلغتنا، وتفهم مشاعرنا، وتخاطب وجداننا، لا أن تكتفي بترجمة جمل جاهزة مستوردة من ثقافات أخرى.
قدَّم الفريق نموذجاً أولياً لتطبيق ذكي يحمل اسم «دَوِّن»، صُمم ليكون أكثر من مجرد برنامج على شاشة الهاتف. يستخدم التطبيق تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (Natural Language Processing – NLP) لتحليل النصوص التي يكتبها المستخدم -سواء أكانت اعترافات صامتة، أم فضفضة عابرة، أم رسائل غارقة في الحزن- ثم يرد بطريقة إنسانية تراعي السياق العاطفي والثقافي للكلمات.
لكن قوة «دَوِّن» لا تكمن في فهم الجمل فقط؛ بل في قراءة ما بين السطور: التقاط الإشارات الخفية في النص، والتمييز بين القلق العابر والاكتئاب المزمن، وبين الحزن المؤقت والاستغاثة الصامتة. وبناءً على ذلك، يمكن للتطبيق تقديم توصيات شخصية، أو إحالة المستخدم إلى مصادر دعم متخصصة، أو حتى اقتراح خطوات عملية للتعامل مع حالته.
إنه ليس طبيباً افتراضياً فحسب؛ بل مساحة آمنة للتعبير الحر؛ حيث يجد المستخدم من يُصغي إليه دون أن يحكم عليه، أو يطلب منه ما لا يستطيع قوله. وربما لهذا السبب، فإن «دَوِّن» يبدو أقرب إلى دفتر أسرارك الذكي، ولكنه دفتر يعرف كيف يرد، ومتى يصمت، ومتى يوجهك برفق إلى من يستطيع مساعدتك في العالم الحقيقي.
لم يكن تصميم «دَوِّن» مجرَّد تمرين برمجي أو مجرد مشروع تقني بارد؛ بل انطلق من إدراك عميق لطبائع الناس في العالم العربي، وحساسية الحديث عن النفس والمشاعر في ثقافتنا. فالتطبيق لا يكتفي باستخدام العربية الفصحى الراقية؛ بل يملك القدرة على التحدث بلهجات محلية محببة للأذن -سواء أكانت خليجية أم مصرية أم شامية- فيجعل الحوار أكثر دفئاً، ويكسر الحاجز النفسي بين المستخدم والآلة.
هذا الإحساس القريب من القلب لم يأتِ مصادفة؛ بل كان جزءاً من فلسفة التصميم منذ اللحظة الأولى. فالفريق أراد أن يشعر المستخدم بأن الطرف الآخر لا يترجم مشاعره؛ بل يفهمها كما هي، وبالنبرة التي كان سيحكي بها لصديقه أو قريب روحه.
وفي تصريح خاص، تقول الباحثة أروى والي: «أردنا أن نصمم أداة تجعل المستخدم يشعر بأنه يُسمَع ويُفهَم بلغته وثقافته، وأن الدعم النفسي ليس امتيازاً للنخبة ولا حكراً على اللغات الأجنبية. الخصوصية كانت أولوية قصوى في كل خطوة من خطوات التطوير؛ لأننا ندرك أن كلمة واحدة يُبوح بها المستخدم قد تحمل أثقل أسراره».
ولهذا السبب، جُهِّز التطبيق بطبقات حماية مشددة تضمن سرية البيانات، دون أن تُثقِل على المستخدم بخطوات معقدة أو رسائل تنبيهات مزعجة. فالغاية أن يجد من يكتب إلى «دَوِّن» ملاذاً آمناً يفضفض فيه بحرية، وهو مطمئن بأن ما يقوله سيبقى بينه وبين ذاكرة رقمية صُمِّمت لتحفظ؛ لا لتفضح».
لم يُصمَّم «دَوِّن» ليكون مجرد دفتر رقمي يدوِّن ما تكتبه ثم يتركه حبيس الشاشة؛ بل جاء كمنصة ذكية قادرة على فهم ما وراء الكلمات، وقراءة نبض المشاعر في سطورك. فهو لا يكتفي بحفظ ما تقول؛ بل يحلِّله، ويفرز ما إذا كان مجرَّد انزعاج عابر يمكن تجاوزه ذاتياً، أو علامة على أزمة أعمق تحتاج إلى تدخل مختص قبل أن تتفاقم.
تصفح أيضًا: رغم اعتذار الهلال… مواعيد سفر القادسية إلى هونغ كونغ «ثابتة»
واعتمد تدريب النموذج على بيانات عربية متخصصة في الصحة النفسية؛ ما مكَّنه من التقاط الفروق الدقيقة التي قد لا يلاحظها حتى بعض البشر. الفارق بين عبارتين مثل: «أنا متعب»، و«لم أعد أحتمل»، قد يبدو بسيطاً لغوياً، ولكنه في الواقع مؤشِّر حاسم على مستوى الخطر العاطفي الذي يعيشه الشخص.
هذه القدرة على التمييز ليست رفاهية تقنية؛ بل قد تكون خط الدفاع الأول عن حياة إنسان. فالتطبيق لا يكتفي بالتشخيص؛ بل يهيِّئ الرد المناسب: نصيحة صغيرة تبعث الطمأنينة في الحالات البسيطة، أو توجيه عاجل لمصادر مساعدة في اللحظات الحرجة.
وبهذا، يصبح «دَوِّن» ليس مجرد ذكاء صناعي يحاكي اللغة؛ بل هو عقل افتراضي يتعلَّم من تفاعلك، ويطوِّر فهمه لأسلوبك الشخصي، ليعرف متى يصغي في صمت، ومتى يمدُّ يده الرقمية لينقذك.
رغم الحماس الذي تثيره هذه التطبيقات، فإن الفريق البحثي يؤكد أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون مساعداً وليس بديلاً عن المعالج النفسي أو الطبيب. فالخوارزمية مهما بلغت دقتها، تظل تفتقر إلى التعاطف الإنساني الكامل، وإلى القدرة على قراءة لغة الجسد ونبرة الصوت في الواقع المباشر. هنا يبرز دور «دَوِّن» كخط أول للدعم النفسي، يخفف الضغط عن العيادات، ويشجع الناس على طلب المساعدة مبكراً، ولكن دون أن يلغي دور البشر.
رغم الأمل الكبير الذي يحمله «دَوِّن» ومنصات الذكاء الاصطناعي المشابهة، فإن الطريق أمامها ليس مفروشاً بالورود؛ بل هو مليء بعوائق تحتاج إلى وعي ومعالجة متأنية:
* القبول المجتمعي: ما زال هناك من ينظر إلى فكرة الحديث مع «آلة» عن أسراره ومشاعره نظرة ارتياب أو حتى سخرية. فكيف يثق إنسان بكيان بلا قلب في أمر يخص قلبه؟ هذا الحاجز النفسي لا يُزال بالتقنية وحدها؛ بل يتطلب تثقيفاً مجتمعياً، وتجارب ناجحة يراها الناس ويلمسون أثرها، حتى تتحول الفكرة من غريبة إلى مألوفة.
* الأمان والخصوصية: في عالم أصبحت فيه البيانات سلعة، تُعدُّ أسرار الصحة النفسية أثمن ما تجب حمايته. لذلك، فإن وضع بروتوكولات صارمة ومشفَّرة لحماية بيانات المستخدمين ليس خياراً؛ بل ضرورة وجودية. كلمة واحدة يكتبها شخص قد تكشف هشاشته أو معاناته، وحمايتها واجب أخلاقي قبل أن يكون قانونياً.
* التكامل مع النظام الصحي: أقوى تطبيق ذكاء اصطناعي يظل محدود الفاعلية إذا بقي معزولاً عن شبكة الدعم الواقعية. ربط «دَوِّن» بمراكز دعم رسمية ومستشفيات وعيادات متخصصة، يضمن أن تكون الاستجابة للحالات الطارئة سريعة وفعَّالة، ويحوِّل التكنولوجيا من أداة مساعدة إلى جزء حي من منظومة الرعاية الصحية.
إذا كُتب لمشروع «دَوِّن» أن يغادر قاعات البحث الجامعي إلى هواتف الناس في كل بيت، فقد نشهد تحولاً نوعياً في علاقة الفرد العربي بالصحة النفسية. تخيَّل ملايين المستخدمين يفتحون هواتفهم في لحظة قلق أو وحدة، ليجدوا «طبيباً افتراضياً» يرحب بهم بعبارة مألوفة: «كيف حالك اليوم يا صديقي؟»، أو: «شلونك؟»، أو حتى: «طمني عنك».
هذا الحوار البسيط، بصوت ولهجة مألوفة، قد يكون الشرارة الأولى التي تدفع شخصاً لطلب المساعدة في وقتها، بدلاً من الانسحاب في صمت. ومع مرور الوقت، قد يتوسع الأثر ليشمل:
– منصات دعم جماعي ذكية، تتيح لمستخدمين من بيئات متشابهة مشاركة تجاربهم تحت إشراف مختصين.
– روبوتات محادثة للأطفال والمراهقين، مصممة للتعامل بلغة تناسب سنهم، وتساعدهم على التعبير عن مشاعرهم بأمان.
– دمج كامل مع التطبيقات الوطنية، مثل: «صحتي»، و«موعد»، بحيث يصبح الدعم النفسي جزءاً من الرعاية الصحية المتكاملة، لا خدمة معزولة.
وربما يتجاوز الأمر ذلك، فنرى مستقبلاً تُدمج فيه تقنيات الواقع المعزز (AR) أو الواقع الافتراضي (VR)، ليجلس المريض وجهاً لوجه مع مستشار افتراضي في بيئة رقمية دافئة، يتحدث ويستمع كما لو كانا في غرفة واحدة.
بهذه الخطوات، قد يتحول «دَوِّن» من مجرد تطبيق إلى ثقافة جديدة في التعامل مع النفس والمجتمع؛ حيث يصبح الحديث عن المشاعر أمراً طبيعياً؛ بل وصحياً… باللهجة التي تطمئن القلب، وتعيد له سلامه.
في نهاية المطاف، يبقى السؤال معلَّقاً في فضاء المستقبل: هل نحن مستعدون لفتح قلوبنا لكيان بلا قلب، على أمل أن يكون أكثر إصغاءً من البشر؟
قد يبدو الأمر غريباً اليوم، ولكنه ينسجم مع روح «رؤية السعودية 2030» التي وضعت الابتكار والتقنية في قلب خططها؛ ليس فقط لتطوير الاقتصاد؛ بل لبناء مجتمع أكثر صحة وتماسكاً. فإذا كان هدف الرؤية أن تجعل المملكة مركزاً عالمياً للتقنيات المتقدمة، فإن دمج الذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية هو جزء من هذا الطموح… طموح يضع الإنسان في المقدمة، ويجعل التقنية وسيلة لتمكينه؛ لا لاستبداله.
ربما، كما قال جبران خليل جبران: «القلب يعرف ما لا تعرفه العقول».
لكن في عصر الذكاء الاصطناعي، قد نضيف: «والعقل إذا صدق في الإصغاء، قد يوقظ في القلب ما ظنه نائماً».
فإذا استطاعت الخوارزميات أن تمنحنا لحظة إنصات صادقة؛ بلا أحكام ولا تسرُّع، فقد تكون هذه هي الخطوة الأولى نحو جسر يعيدنا إلى جوهر إنسانيتنا… لا الذي يبعدنا عنها.