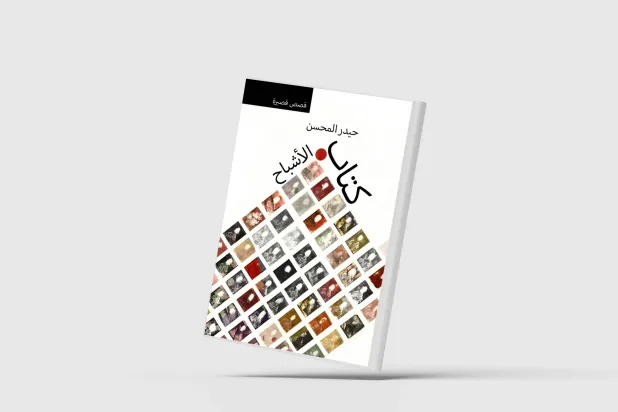في تقديمه لمجموعته القصصية «كتاب الأشباح» – دار التكوين، دمسق- يبرر القاصّ العراقي حيدر المحسن تحويل بوصلة قصصه إلى الماضي بدلاً من الاستمرار في الكتابة عن الحاضر المعيش في العراق، (كما فعل في مجموعاته القصصية الأربع التي صدرت خلال العقدين الأخيرين) كالتالي: الرغبة بتواصله مع الأسلاف ناجم عن أنّ «المستقبل لم يعد ـــ للذين يعيشون في هذه البلاد، أقصد وطني العراق ـــ مغناطيساً وجاذباً» (ص8).
ولتقديم حجة أخرى لقراره بالتوجه صوب الماضي البعيد، استشهد الكاتب حيدر المحسن بما ذكره الروائي الفرنسي فلوبير (المتوفى عام 1880) عن سبب كتابته رواية «سلامبو»: «قليلون هم من سيكتشفون إلى أي حد ينبغي للمرء أن يكون حزيناً حتى يتكبد عناء إحياء قرطاجة».
يقتبس المحسن فقرة أخرى من فلوبير لدعم اختياره الميدان الذي تجري فيه أحداث قصصه: «بما أن القصص يجب أن تكون في الماضي، إذن فكلما كان الماضي أبعد كان أفضل».
ورغم أنني لا أجد أي مبرر لأي كاتب قصصي أن يقدم أي تبرير لقارئه الافتراضي عن سبب اختيار زمان نصوصه سواء كان في الماضي البعيد أو الحاضر أو المستقبل البعيد؛ فالشيء المهم أن يقدم لنا الكاتب أعمالاً ممتعة نتلمس بين سطورها مقدار الجهد المبذول في نسجها.
وإذا طبقنا هذا المبدأ فإنني أستطيع قول إن الكاتب حيدر المحسن نجح في تقديم مجموعة قصصية متقنة الصنعة، ولعل الاستثناء الوحيد في القصص التي تضمنها كتاب «الأشباح» القصة الأولى: «باز» التي بدت لي ضيفاً خفيفاً أكثر مما ينبغي للقصص العشر الأخرى.
العناية بالزخرفة
لعل ما يميز هذه المجموعة القصصية بالدرجة الأولى هو سيادة صوت الراوي تقريباً في سرد كل الحكايات عدا قصة واحدة، وبالتالي لا يستطيع المتلقي سماع أي صوت داخلي لشخصياتها، إلا ما ندر، كأننا هنا نتابع سرد كاميرا سينمائية لأفلام قصيرة، فكما هي الحال مع السينما التي تتقدم الأحداث فيها زمنياً إلى المستقبل نجد قصص هذه المجموعة تتمتع بنفس هذه السمة، فلا مكان لتداعي الخواطر أو تيار الوعي أو العودة إلى الخلف لمعرفة خلفيات الشخصيات. إنهم هنا في هذه اللحظة، وعلينا تقبُّلهم كما هم.
ولتحقيق هذا الهدف سعى الكاتب المحسن إلى زخرفة المشهد في سكونيته بمواد كثيرة تدخل فيها مفردات الزينة والمطبخ والأزهار والعمارة والنباتات والأسلحة… وغيرها، وكل هذه العناصر ستخلق إمتاعاً بصرياً كبيراً لو أن الكاميرا الحقيقية تحل محل القلم. هذا الجهد الكبير المبذول في إعادة بناء المكان الذي وقعت فيه أحداث تاريخية سواء كانت حقيقية أو متخيلة يمنح المتلقي إذا قرأها أو استمع إليها قدرة على تخيلها صورياً كأنه يشاهد أفلاماً قصيرة تجمعها ثيمات مشتركة.
لنأخذ أمثلة من ثلاث قصص لذلك. في قصة «حراب» التي تدور خلال احتضار «الآغا» أحد قادة السلطان عبد الحميد العسكريين بحضور الطبيب الذي استُدعي لعلاجه: «انتبه الطبيب لأول مرة إلى أبواب الصالة العالية والواسعة، وإلى السجاجيد الفاخرة المفروشة، والستائر والوسادات والديوانيات الموشاة بخيطان من ذهب، وإلى التدويرات والمنحنيات والأزهار الصفراء والبنفسجية المشغولة بنعومة على لحاف الآغا». (ص 17).
في فقرة أخرى نتابع الكاميرا (الراوي) في وصفه الباذخ للمكان الذي دخل الطبيب فيه: «على الحيطان سيوف معقوفة ذات مقابض من عاج وبنادق ذات سبطانة مرصعة بالذهب، وحواضنها عليها نقوش بعرق اللؤلؤ والمرجان… الأثاث هنا مثقل بالرخرفة، ومرايا الحيطان منحوتة بأشكال وحوش غريبة: تنانين وسلاحف وأفاعٍ، مع فسيفساء ممزوجة بنقوش عربية».
في قصة «مسرح» نجد أن زخرفة المكان تأخذ طابع المنمنمات حين تصف عين الراوي ثياب الأميرة المسافرة مع عبيدها وخدمها وجنودها لحظة وقوف القافلة ليلاً على الطريق الموصل إلى «الزبير»، وقد يحتاج القارئ الموسوس بالكلمات إلى البحث عن معاني بعض مصطلحات مواد الزينة: «ضحكت، وكان العبد يتملى مدهوشاً الدمقس الأخضر وورود الياقوت المعلقة على ستارة المحمل، وبطانته التي من قطيفة بنفسجية مطعمة بحبات اللؤلؤ… ولكن ما الذي يفهمه العبد شغاتي عن أريج الألوة والبنفسج والرند والعنبرين…» (ص 40-41).
قد يهمك أيضًا: مؤتمر «التراث الشعبي بعيون الآخر»… جوانب منسية من تاريخنا
في قصة أخرى عنوانها «لعبة الملوك» يصف لنا الراوي وجبة طعام يعدها قائد القلعة لضيوفه، فتدخل الأطعمة التي تتناسب مع مرتبة المضيف وكبير الضيوف، وفي هذه القصة فقط استخدم حيدر المحسن ضمير المتكلم بدلاً من ضمير الغائب، لكن ذلك لم يغير شيئاً من الاقتراب من عمل الكاميرا السينمائية التي تقدم لنا مائدة فاخرة بألذ الأطعمة وأشهاها: «مضى الوقت على جناح السرعة رغم أننا كنا صامتين ونحن نأكل، وهذا دليل على جودة الإوزّ المحشو، وكتف العجل المحمّصة بالفستق والزبيب والهيل، وشرائح لحم الغزال المحشوة والمقلية. أما الديك الرومي فقد كان مطبوخاً بصلصة لحم لم أذق مثلها في حياتي…» (ص 63).
الحاضر والماضي
يستنتج المحسن في مقدمته أن اختيار الروائي الفرنسي فلوبير قرطاجة التي دمرتها الجمهورية الرومانية عام 146 قبل الميلاد، جاء لأن «كتابة هذه الرواية… غطاء خيالي لمادة شخصية في حياة الكاتب». (ص 6).
ولعلنا نجد في كثير من قصص هذه المجموعة تكرار ثيمة القتل العشوائي، كأن الرعية بشكل ما مشاريع لفرائس تنتظرها الضواري حتى لو كانت متخمة.
في قصة «حِراب» لم يرتكب الطبيب أي خطأ عند استدعائه لعلاج أحد وجهاء الإمبراطورية العثمانية، ليجد الأخير في مرحلة الاحتضار. وحال وفاته يأتي الحكم القاطع على لسان كبير أفراد العائلة الأعمى: «لماذا قتلت الآغا؟ من الذي دفعك للقيام بذلك؟»، وقبل أن يجيب الطبيب مدافعاً عن نفسه يصفق الآخر بيده فينهال الحاضرون عليه طعناً ليمزقوه بالحراب.
ولعل هذا التهديد لحق ببعض الأطباء العراقيين بعد حل الدولة ومؤسساتها على يد الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بعد احتلال العراق عام 2003 وصعود سلطة العشيرة، ففي كثير من الحالات كانت عائلة المريض تطارد الطبيب إذا فشل في إشفائه حتى لو كانت وفاته ناجمة عن مرض عضال.
يتكرر هذا القتل في قصة أخرى (قد تكون حقيقية تاريخياً)، لكنها تحولت هنا بكاميرا القاص حيدر المحسن إلى فيلم ذي ثلاثة أبعاد وعلى ملء الشاشة وبالألوان. تحمل القصة عنوان: «حكاية المعماري صلاحي مع الشاه». وهذا الإمبراطور الفارسي يدعى «سيفي» بعد حفل عشاء نظمه للسفراء الأجانب احتفالاً بصيده 30 أيلاً في يوم واحد.
وكان لحم هذه الحيوانات البرية جزءاً من العشاء الفاخر الذي نظمه لضيوفه. وشاءت المصادفة أن يحضر المعماري «صلاحي» خلال الحفل ليبشر الشاه بنجاحه في بناء هرم برؤوس الأيائل الثلاثين في وسط المدينة، وكل ما يحتاج إليه الآن رأس أيل واحد ليضعه في قمة هذا الهرم كي يكتمل النصب.
لكن الملك ومن دون أي سبب سوى أنه اتبع نزوة قفزت إلى ذهنه، يأمر بقطع رأس المهندس المعماري صلاحي لملء الفراغ المتبقي من الهرم، فيتم تنفيذ الأمر على عجل.
ونحن نتابع ما يجري اليوم يبدو لنا أن هذه القصص تتكرر في الجوهر مع اختلاف ضئيل في التفاصيل الثانوية: الماضي يتلبس الحاضر بشكل ما.
في مقدمته يفسر حيدر المحسن للقارئ سبب اختياره عنوان كتاب «الأشباح»: «لأن جميع الشخوص فيها غادرونا منذ زمان طويل، ويظهرون للقارئ بين الصفحات بهيئة شبحية، وأعلى ما يطمح إليه الكاتب هو أن يفعل سحر الفن فعله، وتبدو الأشباح، عندها حقيقية مثل الناس الذين يعيشون بيننا، وربما كان لهم تأثير أقوى في حياتنا».
وقد اتفق أن هناك سحراً للفن في هذه المجموعة القصصية، ولكن هل من الضروري مصادرة حق القارئ بتأويل العنوان كما يشاء؟